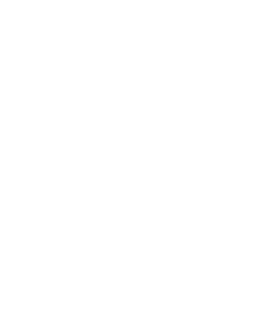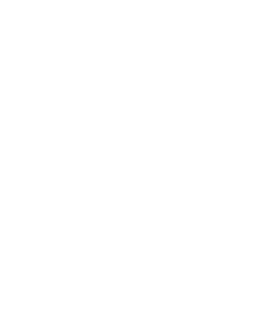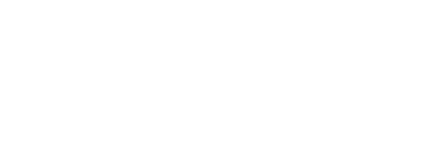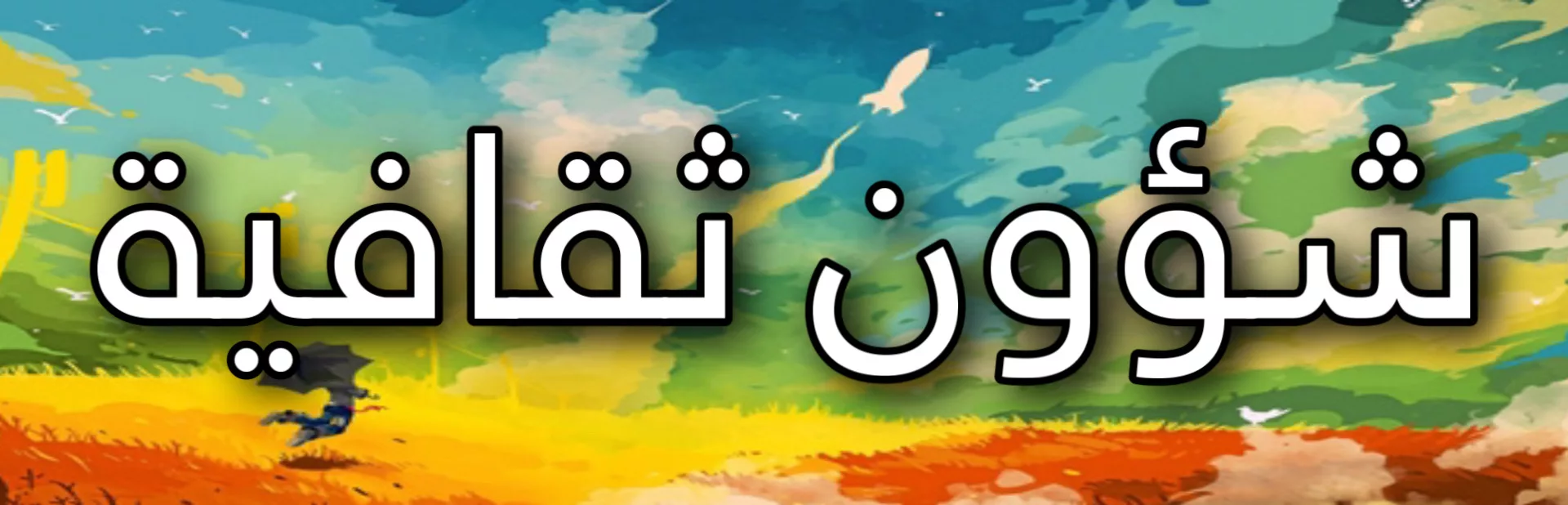أخبار عاجلة
- احتجاز رجل في مستشفى بعد ادانته بإضرام النار بشخصين مسلمين في بريطانيا
- الداخلية تنتفض لمواجهة الأكياس البلاستيكية الممنوعة
- توقعات أحوال الطقس ليومه الخميس
- الأطباء الداخليون والمقيمون يضربون يومه الخميس احتجاجا على “الاستهتار الحكومي” مع مطالبهم
- جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية
- توقيف شخص بمدينة طنجة في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات
- المغرب واسبانيا عازمان على تطوير التعاون في البحث والتعليم العالي
شؤون سياسية
جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية
عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، جلسة مغلقة حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، حيث قدم المبعوث الشخصي للأمين…
دولية
احتجاز رجل في مستشفى بعد ادانته بإضرام النار بشخصين مسلمين في بريطانيا
أصدر قاض الأربعاء بحق رجل أدين بمحاولتي قتل لإضرامه النار عمدا برجلين مسنين بعد وقت قصير على مغادرتهما مسجدين…
حوادث
توقيف شخص بمدينة طنجة في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق…
فن و ثقافة
مصطفى الزعري يتلقى العلاج بالمستشفى العسكري بالرباط
نقل الفنان المغربي مصطفى الزعري إلى المستشفى العسكري بالرباط، لتلقي العلاج، بعد تدهور وضعه الصحي، إثر إصابته بداء…
صحة وأسرة
دراسة.. الشعور بالوحدة قد يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة…
حذرت دراسة أمريكية حديثة من خطورة الشعور بالوحدة على صحة الإنسان، حيث يمكن أن تزيد من احتمالات إصابته بالأمراض…
الداخلية تنتفض لمواجهة الأكياس البلاستيكية الممنوعة
دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات لإصدار توجيهاتهم لممثلي الإدارة الترابية وحثهم على دعم ومواكبة المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في تطويق ظاهرة إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأكدت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن خطوة وزارة الداخلية، تأتي في ارتباط بالقرارات الوزارية التطبيقية…
الأكثر مشاهدة
استطلاع أنوار بريس