-
محمد زروال (°)
تزخر الفيلموغرافيا المغربية بمعطيات وافرة عن الخصوصيات الثقافية والتاريخية للمجتمع المغربي،فالأفلام المغربية عبارة عن فسيفساء تتمظهر من خلالها مظاهر التنوع والتعدد والثراء. لكن الملاحظ للوهلة الأولى أن الإبداع السينمائي ركز على جوانب معينة من الثقافة المغربية بعد الاستقلال مقابل ذلك أهمل العناصر الأخرى وأبعدها عن ممكنات التوظيف الجمالي، إلا أن التأمل في مجمل ما أنتجته السينما المغربية منذ الستينيات إلى اليوم يكشف معالم وتشكيلات الغنى الثقافي بالمغرب، وذلك من خلال ما تتضمنه هذه الأفلام من رموز وعلامات، ففي طيات كل فيلم هناك تكثيف لهذه الرموز والعلامات، لتخدم في النهاية بنية الفيلم، وتمنحه هويته الفنية، وتبني مرجعيته الفكرية.
تشكل العلامات والرموز الأمازيغية نموذجا بارزا لهذا الحضور في السينما المغربية، إذ نرصد تجليات كثيرة لعناصر الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وهو حضور يتداخل في الكثير من الحالات مع رموز أخرى، لدرجة يصعب معها أحيانا لدى المتلقي، بل ولدى بعض المبدعين أنفسهم، التمييز بين هذه العلامات الأمازيغية والعلامات الثقافية واللغوية الأخرى، بسبب التسويق منذ عقود لمفاهيم الوحدة في ظل العروبة والإسلام، والارتباط الوثيق بالشرق، وحتمية الانتماء إليه.
وفي المقابل كان هناك إقصاء للأمازيغية كعنصر أساس في بنية العمق الحضاري للمغرب. سنقتصر في هذا المقال على رصد بعض تجليات هذا المكون الأمازيغي في السينما المغربية، من خلال التركيز على اللغة و الرموز التاريخية، والطوبونيما الأمازيغية.
اللغة الأمازيغية والنضال من أجل إثبات الذات
يلاحظ المتتبع لمسار للسينما المغربية منذ بداياتها أن الأمازيغية كلغة للحوار، لم تكن متداولة في الأفلام، إذ كان كتاب السيناريو يعتمدون على الدارجة المغربية أو العربية الفصحى أو اللغة الفرنسية، لأنها ألسنة كان لها حضور رسمي، بينما اللغة الأمازيغية كانت طابوها سياسيا في مغرب ما بعد الاستقلال، وهو ما انعكس سلبا على مكانتها في الإبداع عامة، وللتأكيد على محاربة الأمازيغية نستدل باعتقال الأستاذ على صدقي أزايكو سنة 1982 بعد نشره لمقال حول معنى الثقافة الوطنية، والذي أشار فيه بطريقة غير مباشرة أن اللغة الأمازيغية تشكل عمقها الحقيقي.
لم تستمر هذه الوضعية بطبيعة الحال، فقد انعكس التحول السياسي في المغرب منذ منتصف التسعينيات على وضعية الأمازيغية، واستطاعت بلوغ مرحلة الترسيم في دستور 2011، رغم ما يحاك ضدها من مكائد في ظل الوضعية الراهنة. وبخصوص حضور اللغة الأمازيغية في الوسائط البصرية، فقد سمح بتصوير أفلام الفيديو منذ نهاية الثمانينيات، ومنتصف التسعينيات أدمجت الأمازيغية في نشرات الأخبار.
ومع بداية الألفية الثالثة تم تصوير أولى الأفلام السينمائية باعتماد اللغة الأمازيغية في الحوار، ونورد هنا كل من فيلم” إيموران” 2001 لعبد الله داري، و” تيليلا” لمحمد مرنيش 2006 و”إيطو تتريت” 2008 لمحمد عبازي، وهذه الخطوات يمكن إدراجها ضمن مسارات النضال الأمازيغي السينمائي، بعدما اقتنع مجموعة من الفنانين والمهتمين أن لغتهم قادرة على استيعاب التعبير في السينما والتلفزيون، وغيرها من الفنون، عكس ما كان يروج أنها لهجة فقيرة غير قادرة على المواكبة إبداعيا وفكريا.
وقد تحققت هذه المكاسب سينمائيا بعد مرحلة انتقالية تميزت بإدراج بعض الحوارات بالأمازيغية مثلما نجد في فيلمي” من الواد لهيه” و” كنوز الأطلس” للمخرج محمد عبازي. وهكذا يمكن تتبع مسار المصالحة مع الأمازيغية بالمغرب من خلال مكانتها في قطاع السمعي البصري عامة، والسينما تحديدا.
تاريخ الأمازيغ نبع إلابداع السينمائي المتجدد
يبرز المكون الأمازيغي في الأفلام المغربية على المستوى التاريخي، إذ أن تناول تاريخ المغرب، كان ولا زال هما وانشغالا بارزا في مشاريع السينمائيين المغاربة، ولو أن الحقبة المعاصرة أكثر تناولا. وظفت السينما المغربية الشخصيات الأمازيغية في اشتغالها على المعطى التاريخي، سواء كان ذلك مقصودا مثلما نجد لدى محمد عبازي في فيلمه” إيطو تتريت”، أو فيلم “أدور”، لأحمد بايدو، أو بشكل غير مقصود، وهو ما نلمسه في أفلام كثيرة.
تحضر الشخصيات الأمازيغية باعتبارها رموزا بصمت فترات من تاريخ المغرب، وصنعت مجده بين الأمم. ويندرج تناول مثل هذه المواضيع في إطار تمثل السينمائيين المغاربة لتاريخ بلدهم، ومحاولتهم تقديم بعض محطاته ومنعطفاته سينمائيا، بغية إعادة الاعتبار للمساهمين في صناعته، وتوعية أجيال اليوم بتضحيات الأجداد من بوابة الصورة السينمائية، فمثلا فيلم “زينب زهرة أغمات” للمخرجة فريدة بورقية، ينقل المشاهد إلى مغرب العصر الوسيط، زمن الدولة المرابطية، التي وضع دعائمها كل من أبي بكر بن عمر اللمتوني، ويوسف بن تاشفين، وينتميان معا لقبيلة صنهاجة الأمازيغية.
والجميل في هذا الفيلم، رغم بعض هفواته التاريخية، أنه يكشف المكانة المرموقة للمرأة في المجتمع الأمازيغي، إذ كانت “زينب النفزاوية” إضافة إلى جمالها، ذات رأي ومشورة في أمور الدولة التي كانت حصة الأسد في تدبيرها للرجال، وهكذا يصبح التاريخ في الفيلم وسيلة لتأصيل أحقية المرأة في القيادة، والمشاركة الفاعلة إلى جانب الرجل، وتكريس ثقافة المساواة بين الجنسين، وهذا ما نقف على تجلياته في سير شخصيات نسائية أخرى من شمال إفريقيا كديهيا ملكة الأوراس، و”تين هينان” ملكة الطوارق في الصحراء…
ركز المخرجون المغاربة في تناولهم لتاريخ المغرب على الحقبة المعاصرة، والزمن الراهن، بحكم تجدد النقاش حولها، وقابلية ظروف الإنتاج المتوفرة في المغرب على تنزيل تلك السيناريوهات على أرض الواقع، بينما كلما ابتعدنا زمنيا، تتضخم العراقيل، ويصعب توفير مستلزمات الإنتاج.
اشتهرت أفلام كثيرة بتمجيد أبطال المقاومة، في مواجهة الاستعمار الفرنسي والإسباني كفيلم “44 أو أسطورة الليل” لمومن السميحي، الذي تناول كرونولوجية المقاومة المسلحة والسلمية في مواجهة الغزاة، ويشير الفيلم إلى زعماء المقاومة المسلحة البارزين، على رأسهم محمد بن عبد الكريم الخطابي زعيم معركة أنوال 1921 ، وموحى أحمو الزياني، الذي قاد قبائل زيان وإشقيرن… لهزم الفرنسيين في معركة لهري سنة 1914. وهو ما يطرحه فيلم “بامو” للمخرج إدريس المريني الذي يتناول تجربة أخرى من مقاومة الاستعمار الفرنسي بالأطلس المتوسط.
برز الاشتغال كذلك على التاريخ الراهن في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفيه نلمس حضورا لهذا البعد الأمازيغي، فمثلا فيلمي” أشلاء” و” ثقل الظل” لحكيم بلعباس يتناول حكاية مريرة لاختفاء “حماد أتكو” من منطقة بومالن دادس في الجنوب الشرقي للمغرب، ومن خلال سرد تجربة هذه الأسرة نقف عند حجم التهميش والإقصاء الذي مس هذه المناطق، واستمرار معاناتها مع هذا الماضي المر، فأم المختطف التي توفيت دون معرفة مصير ابنها لا تتحدث إلا الأمازيغية، ووجدت صعوبة في نقل حسرتها على ابنها، لكن ملامح وجهها تعبر بحرقة عن آلم الفراق.
ومن اللقطات المعبرة في فيلم “أشلاء” تصريح الأم للمخرج بكونها لم تر وجهها في المرآة منذ اختطاف ابنها حماد، وهو تلميذ داخلي بإحدى المؤسسات التعليمية بورزازات. هذه المرحلة الصعبة نالت من سوادها، واكتوت بلهيبها قرى بأكملها في مناطق مختلفة من المغرب، ولاتزال في حاجة إلى المزيد من التوثيق والاشتغال السينمائي.
الطوبونيم الأمازيغي، هوية المكان الصامدة
يعتبر المعطى الطوبونيمي، فضاء ولباسا ثقافيا للمكان، وما يصنع انتماءه وخصوصيته، وتتحكم تراكمات الماضي، ومتغيرات الحاضر في تشكيله. وتكمن أهمية الطوبونيميا في كونها علامة ثقافية صامدة أمام العنف الرمزي للأنظمة السياسية، فهو عنصر يستقر في ذاكرة الناس، ويلتصق بألسنتهم، وينفلت من سياسات الطمس والتعتيم، فقد تتغير لغة قوم ما، لكن الطوبونيميا تظل مقاومة، وشاهدة على ماضي المكان وخصوصيته.
وإذا ربطنا هذه النقطة بحضور المكون الأمازيغي في السينما المغربية، سنجد الكثير من الأفلام المغربية تحمل في طياتها أسماء أماكن عريقة، تربطنا مباشرة بالثقافة الأمازيغية التي حافظت على استمراريتها، فمن خلال تلك الأسماء يتشكل الانتماء الحقيقي للمكان بما فيها أسماء الكثير من المدن المغربية كطنجة وتطوان وأنفا…، فإذا كان كتاب السيناريو يختارون أسماء الشخصيات من منطلقات ذاتية، فإن أسماء الأماكن كالمدن والأحياء والقرى، تفرض نفسها حتى ولو تعلق الأمر بالأفلام الروائية، أما الأفلام الوثائقية فلا مفر من إدراج هذه المعطيات الطوبونيمية، التي تشكل ركيزة أساسية في البنية الداخلية للفيلم .
يمكن أن نستدل على إدراج الطوبونيم الأمازيغي بفيلم “الجامع” لداود أولاد السيد الذي تدورأحداثه بالجنوب الشرقي( زاكورة)،إذ نجده غنيا بأسماء الأماكن الأمازيغية مثل” تمتيك” و” تامكروت”، اللذين يحيلان على مميزات المجال ثقافيا، وينطبق ذلك على فيلم” محاولة فاشلة لتعريف الحب” لحكيم بلعباس حيث بنى فكرة الاشتغال في الفيلم على أسطورة” إسلي” و” تسليت”( العريس والعروس)، وهما طوبونيمان مهيكلان للبناء الداخلي للفيلم، كما أنهما شكلا بوابة لفهم تنظيم وهندسة المجال، وغيرها من المعطيات التي تؤكد خصوصية مجال أيت حديدو قبليا، واجتماعيا، وتنمويا.
يحضر هذا المنحى كذلك في فيلم ” طين جا” للحسن الكزولي الذي ربط اشتغاله بالمكان الماكروسكوبي (المغرب/ مراكش)، والميكرسكوبي قرية “أدرج” نواحي مدينة بولمان، وكلاهما يتضمنان خلفيات وجدانية وثقافية وقيمية، علما أن الفيلم من جنس الروائي، إلا أنه لا يخفي ذاتية المخرج، بل يحيل مباشرة على التشبث بالجذور، وكانت الطوبونميا ملاذا حاسما للتوقيع على هذا التعلق.
وهكذا فإن الطوبونيمات الأمازيغية في السينما المغربية تدرج بطرق مختلفة، ويكون الاختيار في الغالب اعتباطيا، باعتبارها علامات من الفضاء الفيلمي، تحمل بالنسبة للمخرج دلالات خاصة، وقد لا تتوافق مع معناها الحقيقي، لكنها تشكل شواهد على عراقة المكون الأمازيغي، وصموده أمام كل سياسيات الطمس والتحيين المؤدلجة.
نختم هذه المقالة، بالإشارة إلى غنى الخزانة السينمائية المغربية بما يشكل مرجعا أساسيا لفهم التحولات التي عرفها المغرب الراهن، كما تتيح هذه الأفلام السفر في التلوينات الثقافية بالمغرب، فكل فيلم عبارة عن بطاقة عبور نحو اكتشاف عوالم مرحلة تاريخية معينة ، أو حكاية مكان ما في المركز أو في الهامش.
ــــــــــــــــــــ




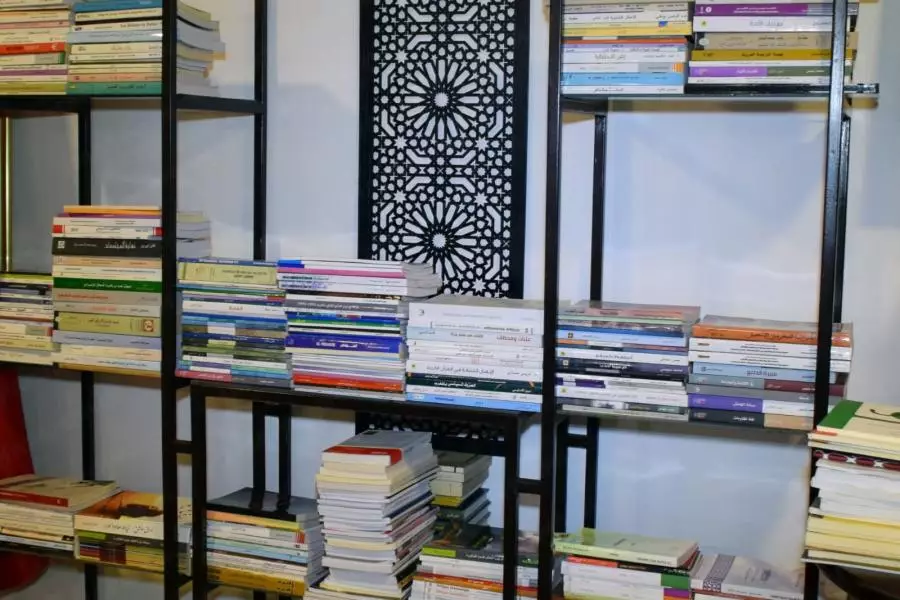







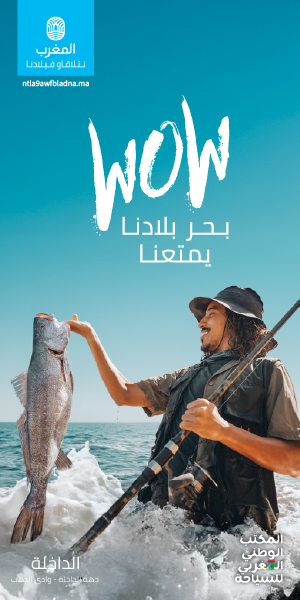
تعليقات
0