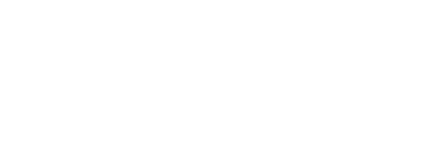في ذكرى رحيل المناضل الديمقراطي التقدمي السي عبد الرحيم بوعبيد
السي عبد الرحيم بوعبيد ثقل التاريخ وحلم الكائن
تحل يوم غد الأحد 8 يناير 2023 الذكرى 31 سنة على وفاة رحيل المناضل والقائد الوطني الديمقراطي التقدمي عبد الرحيم بوعبيد ، بعد مسيرة طويلة من النضال داخل صفوف القوات الشعبية.
ازداد السي عبد الرحيم بوعبيد في 23 مارس 1920 بسلا . بدأ حياته معلما في التعليم الابتدائي بإحدى المدارس بفاس. وفي سنة 1941 حصل على الباكالوريا. وقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهو أصغر موقع عليها، واعتقل من طرف سلطات الحماية الفرنسية إثر الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة سلا.
نجا بأعجوبة من حبل المشنقة، بعد اتهامه بقتل جندي فرنسي أثناء قيادته المظاهرة. قضى 18 شهرا في سجون سلا، العادر، المدني اغبيلة بالدارالبيضاء، والفلاحي. و التحق بالعاصمة الفرنسية لمتابعة دراسته الجامعية.
![]() كان يمثل الحركة الوطنية بفرنسا، ورئيسا للوفد الوطني لدى الأمم المتحدة بباريس عندما كان مركزها بفرنسا، و عاد إلى المغرب، ليمارس مهنة المحاماة، وأصبح أنذاك من أصغر أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. وفي 26 ماي 1962 قدم تقريرا أساسيا هاما إلى المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالدارالبيضاء.
كان يمثل الحركة الوطنية بفرنسا، ورئيسا للوفد الوطني لدى الأمم المتحدة بباريس عندما كان مركزها بفرنسا، و عاد إلى المغرب، ليمارس مهنة المحاماة، وأصبح أنذاك من أصغر أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. وفي 26 ماي 1962 قدم تقريرا أساسيا هاما إلى المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالدارالبيضاء.
وفي 10 يناير 1975 قدم تقريرا سياسيا إلى المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وانتخب ضمن أعضاء المكتب السياسي ثم كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،إلى أن وافته المنية بتاريخ 8 يناير 1992.
لاشك أن المصير العجيب والتقلبات العنيفة التي عاشها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ، جديرة بأن تكون موضوعا لرواية خيالية.
لكن ما حدث له ليس أمرا استثنائيا لأن الوقائع التي عاشها هي نفسها التي عرفها المغرب منذ أن كان عبد الرحيم بوعبيد معلما بفاس في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين.
يخرج كل صباح من سكناه بحي الدوح في اتجاه مدرسة اللمطيين، وهو يرسل نظرته النفاذة إلى ملامح المدينة شبه النائمة، دون أن يجد في المدينة مغامرة حياته التي اشتهاها، لدرجة أنه اكتشف ذات يوم أن التعليم ليس مهنته، ولذلك فكر في أن يتطوع في الجيش الفرنسي بعد أن اندلعت الحرب الثانية، وكانت هذه النزوة بداية الاهتمام بحالته، ولذلك تم إنذار أعضاء الحزب الوطني بماكان سيقدم عليه عبد الرحيم، ونجح حينذاك المهدي بنبركة، إضافة إلى أحمد مكوار وامحمد بن سودة في إقناع الشاب السلاوي بأن تلك الوجهة الغريبة لا تليق بأمثاله.
كانت تنتظره حرب أخرى أطول نفسا وأشد فتكا، ولذلك زال الإحساس بالغربة في فاس وهو يكتشف لذة تحرير بلد بأكمله.
![]()
لن يستطيع أحد وصف تلك الابتسامة الأخّاذة التي ارتسمت على محيا عبد الرحيم بوعبيد، وهو يتخذ قراره الذي لا رجعة فيه وقتذاك.
لقد نجح في اختبار الآخرين بضرورة وجوده بينهم وتطلع منذ تلك الفترة إلى أن يعود من حيث أتى، لا ليوفر نصف الأجرة التي كان يرسلها إلى والديه في سلا فقط، ولكن ليكون أيضا قريبا من مركز القرار، حيث تحضّر السياسة الاستعمارية، وحيث الأصدقاء الكثر لهم نفس اللغة، خصوصا وقد تركهم خلفه في معهد مولاي يوسف.
انقطع عن دراسته ليعول نفسه ووالديه، وهم مازالوا يتابعون دراستهم الثانوية.
في سلا التي عاد إليها بعد سنتين من الغياب ليدرّس بمدرسة أبناء الأعيان، كان عبد الرحيم بوعبيد أصغر معلم في هذه المدرسة الوحيدة بالمدينة، وربما تذكر مجددا تلك العطل الصيفية التي كان يقضيها في توسيع معرفته بالثقافة الإسلامية والعربية ومناقشاته الهادئة عن الشعر الجاهلي، وبالخصوص عن شعر امرئ القيس وعنترة وطرفة بن العبد وعلقمة الفحل.
![]()
ولدرجة يدهش فيها المرء لسعة معلوماته حول موضوعات ليست من تخصصه مع أن سنه لم تتجاوز الخامسة عشرة.. لكنه، وهو هذه المرة يعود إلى سلا مثقلا بهمّ مختلف، وبأفق جديد، أصبحت كلماته أكثر تشويقا وسحرا، يحكيها أطفال أعيان سلا لآبائهم، لدرجة فرضت تلك السمعة على المسيو دارلي، مدير المدرسة، احتراما استثنائيا لهذا المعلم النحيف، مشوب بقليل من الشك والريبة.. لم يكن عبد الرحيم وقتها قد اشترى دراجة، كما فعل آخرون ليتنقل بها بين الرباط وسلا، كان يبدو عازفا عن أي شيء مع أنه دوما محافظ على أناقته المغربية التي لا تضاهى، رغم أن تلك الأناقة تتخذ أحيانا ذلك الطابع الإفرنجي النادر، تعززه تلك القامة والمحيا الدقيق، المطبوع بتركيز الكائن ككل، أحيانا يتلطف فيرسل تلك الابتسامة الرقيقة الحيية، وأحيانا أخرى يخفض جفنيه في نوع من الخجل.. لكن ذلك لا ينم عن رخاوة أو حِلْم، بل ينم عن إرادة لها طابع هادىء، لا تتزعزع، لأن تلك الجفون تكشف فجأة عن نظرة حية، نفاذة، يتخللها ذلك النور الخاطف الماكر الذي يكاد يكون طفوليا.. ويطبع شخصيته ومزاجه الهادىء، المثير للإعجاب.
كان محمد اليزيدي، مثل غيره ممن أعجب بعبد الرحيم، المعروف عنه أنه يفكر باستمرار في الآخرين، هو أول من عرض عليه الانضمام إلى الطائفة، أي إلى الخلية السرية للحزب الوطني، حدث ذلك في نهاية 1941، مباشرة بعد عودته إلى سلا، وكما كان مفروضا، أثبت عبد الرحيم بكل ما يملكه من طاقة عقلية وقدرة على استيعاب الحقائق من حوله، أن كل معطيات القضية الوطنية كانت واضحة، ولذلك تابع أحداث الحرب الثانية وأفقها المفتوح على تحرير المغرب، دون أن يلتجىء إلى بناء أي من الأوهام التي روجها غيره، ومكنته، تبعا لذلك، وضعيته كعضو في الخلية السرية للحزب الوطني، من معرفة أعمق بالملف المغربي، وانعطافاته وتشابكاته.
![]()
لكن اعتقاله في يناير 44، غداة تنظيم أضخم مظاهرة شعبية عرفتها سلا في أعقاب إلقاء القبض على أحمد بلافريج، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونائبه محمد اليزيدي بتهمة التواطؤ مع دول المحور، وهي المظاهرة التي كانت من تنظيمه، كانت نقطة تحوّل أساسية، فمدة خمسة عشر شهرا التي قضاها في السجن، كانت العربون الأول الذي تلقاه عبد الرحيم بوعبيد من الإدارة الاستعمارية ببرودة أعصاب، وبسخرية.
بعد صعود الحكومة المؤقتة إثر نهاية الحرب التي كان يرأسها الجنرال دوغول، تم إطلاق سراح عبد الرحيم بوعبيد، باستثناء من كان منفيا في الكابون أو في الصحراء (علال الفاسي، والوزاني)، وبمرور بضعة شهور (خريف 45) سيتقرر، بعد استئناف النشاط الوطني، أن يلتحق عبد الرحيم بفرنسا، من جهة، لكي يمارس مهامه الجديدة كممثل للحزب في العاصمة الفرنسية وكمسؤول عن الطلبة والجالية المغربية عموما، ومن جهة ثانية، ليتابع تكوينه الذي انقطع بسببه عن متابعة الدراسة واشتغاله بالتعليم الابتدائي.
في باريس سيكون عبد الرحيم على موعد آخر متصل بالنخبة السياسية والثقافية والإعلامية لفرنسا، سيندمج في علاقات متعددة لا تمثل شبكة، بقدر ما تمثل مجموعة علاقات متساندة يحكمها التعاطف والصراع في نفس الوقت، وهكذا، وشيئا فشيئا سيوصل عبد الرحيم كلماته الرقيقة إلى تلك النخبة التي يوجد من بينها شارل أندريه جوليان، وألبير كامو وفرانسوا مورياك، وكلود بوردي وروبير باي، وجان لاكوتور فيما بعد.. وسيتابع بنفس الاهتمام الذي يوليه لتطورات قضية بلاده، ما يجري في فرنسا من أحداث اقتصادية وسياسية بالغة الدلالة، أهمها قرارات التأميم التي أقرها رئيس فرنسا الحرة، دوغول، ضد شركات لها موقع نافذ وحيوي بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، كما سيتابع باهتمام أكبر، مآل المفاوضات التي انتهت إلى الفشل حول ما سمي بالقانون الأساسي لأقطار الهند ـ الصينية: فيتنام، لاووس، وكمبوديا، وحول ما كان يعرف بالاتحاد الفرنسي، تم الاهتمام بهوشي مينه، وعودته إلى بلاده واندلاع حرب استعمارية دامت ثماني سنوات في الهند الصينية.
من جانب آخر، سمحت له متابعة المحاضرات بمعهد الدراسات السياسية بزنقة سان كيوم بأن «يستوعب تطور الفكر الاقتصادي وأن يتعرف بالأساس على التوجه الكينزي الذي كان له في ذلك الوقت إشعاع كبير، لأنه يكوّن الأساس النظري لتدخل الدولة، سواء في مواجهة الأزمة الاقتصادية قبل الحرب، أو لتأطير تشييد الاقتصاديات المنهارة بفعل هذه الأخيرة».
وقد تهيأ له مباشرة بعد خروجه من السجن أن يتابع السياسات التي كانت تنهجها إدارة الحماية بعد الحرب على عهد المقيم العام إيريك لابون، والمستندة إلى نظرية الازدواجية الاقتصادية والهادفة إلى إدخال متغيرات جديدة عبر تحديث القطاع الفلاحي التقليدي بإيعاز من بعض المختصين الاجتماعيين مثل جاك بيرك، والزراعيين مثل جوليان كولو والجغرافيين مثل جون دريش، وهي شخصيات تعرف عليها عبد الرحيم بوعبيد عن قرب، وقد سعت نفس السياسة «إلى توسيع فضاء الاقتصاد الرأسمالي وإحداث جسور الارتباط بين المعمرين والمجتمع المغربي مما يفتح المجال لميلاد بورجوازية مغربية يطلب منها أن تساهم في المشروع التحديثي للحماية» في 49 سيعود عبد الرحيم إلى المغرب، وفي ذهنه مقولات الاشتراكيين في مجال السياسة الاقتصادية، انطلاقا من تجربة «الجبهة الشعبية» التي أشرف عليها ليون بلوم، و كانت صدى لنمط التطور الاقتصادي بالاتحاد السوفياتي ذي الجاذبية آنذاك، رغم أنه تابع بدهشة تلك الظروف التي أدت إلى الانقسام بين أحزاب اليسار: الفرع الفرنسي للأممية العمالية والحزب الشيوعي، والحركة الجمهورية الشعبية، مما خلق شروطا أدت إلى الهيمنة التدريجية لليمين، وتقلص نفوذ التيار الليبرالي…
وفي المغرب الذي غاب عنه عبد الرحيم جسديا أزيد من أربع سنوات متصلة، وبعد أن يستقر بمكتب المحاماة بالرباط كمساعد للأستاذ دارّو D..rroux سيفاجأ الذين لم يكونوا على صلة مباشرة به بقوة ذلك المنطق الذي أصبح يستعمله لانتقاد السياسة الاستعمارية، لقد أصبح مشرفا على جريدة الحزب الأسبوعية «الاستقلال» وأصبح يكتب افتتاحياتها التي لم تكن أبدا تشبه مثيلاتها، لا بسبب قوة أسلوبها ونقاء لغتها، ولكن بسبب الدقة التي تحكم مضامين تلك الافتتاحيات والمتجهة بالأساس نحو انتقاد السياسة الاستعمارية، ودحض مبرراتها وأهدافها عن طريق حجج شبهت «بالحجج الديكارتية» رغم أن هذه العبارة اشتهرت بعد ذلك حين قالها إدغار فور عن عبد الرحيم عقب مباحثات إيكس ليبان.. بالطبع، كان من قراء «الاستقلال» وافتتاحياتها بالخصوص الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وقد دفعته تلك الافتتاحيات إلى مزيد من التعمق فيما يحدث حوله، بل إلى تبني أفكارها وحججها، ولذلك حين فكر في تقديم مذكرة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، فانسان أوريول، خلال زيارة جلالته لباريز في أكتوبر 1950، يطلب فيها التخلي عن معاهدة 1912 وتعويضها باتفاقية جديدة تراعي التغيرات وما تم إنجازه، تم إلحاق عبد الرحيم بالمجموعة الصغيرة التي عهد إليها بإعداد أهم مذكرة حررت في وقتها.
ورغم أن الرئيس أوريول كان يتفهم مطالب الوطنيين في المغرب، كما هو الحال في تونس، فإن البرلمان الفرنسي المحكوم من الأغلبية اليمينية آنذاك كانت بيده حرية التصرف، وعاد الملك خائبا، الأمر الذي دفع عبد الرحيم إلى كتابة افتتاحية في «الاستقلال» قال عنها الأستاذ عبد الرحمان القادري فيما بعد بأنها من «أروع ما كتب» و «قرأناها ونحن تلاميذ في الرابعة من الثانوي»، وكانت بعنوان: «دفع بعدم القبول» ويوجد حدث له مدلول هام في حياة عبد الرحيم وهو الذي تلا المفاوضات الفرنسية ـ التونسية حول الحكم الذاتي التي انتهت إلى الفشل، وما أعقبها من اعتقال بورقيبة واغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد في أواخر 52 ستعرف الدار البيضاء شللا نتيجة الإضراب العام الناجح، الأمر الذي سينتج عنه لجوء الإقامة العامة إلى إصدار مرسوم بحل ومنع حزب الاستقلال واعتقال قادته الوطنيين، وتقديمهم للمحكمة العسكرية بالدار البيضاء و «تم اعتقال عبد الرحيم بوعبيد نفسه خلال الليل واقتيد إلى السجن بملابس النوم دون السماح له حتى بأخذ بعض ملابسه، وزج به في زنزانة واحدة مع [من أطلقت عليه الصحافة الاستعمارية] لقب «جزار تادلة» والمقصود به الشهيد الحنصالي، وبعد 22 شهرا تخللتها أحداث غشت 53 الخطيرة، كان على هذه الوضعية أن تنتهي في أحد أيام شتنبر 54 بعدم المتابعة، خصوصا أن الأحداث أخذت تتحرك، سواء في المغرب أو في فرنسا من منطلق أن الحسم لن يتم في الرباط، بل في باريس.
هكذا سيلتحق عبد الرحيم مجددا بباريس بعد أن رفض إجراء أي محادثات مع فرانسيس لاكوست، المقيم العام، وفي باريس تتبع تطور المفاوضات التونسية ـ الفرنسية وسقوط حكومة مانديس فرانس، واعتراف الحكومة التالية بقيادة إدغار فور بالحكم الذاتي لتونس الذي كان علامة على قرب حدوث انفراج في الملف المغربي.. وكذلك كان، إذ سيستدعيه إدغار فور ليناقش معه إمكانية تحديد موعد لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف، وفي إيكس ليبان، وبالضبط في صيف 55، سيكون عبد الرحيم مستأثرا باهتمام الصحافة الفرنسية هو وزملاؤه اليزيدي وبنبركة وبن عبد الجليل، وبالخصوص من طرف لوموند، ووقتها قيل عنه إنه «مفاوض يجمع بين الذكاء وبعد النظر، والتركيز على الجوهر» خصوصا حين قدم «مرافعته» الشهيرة التي تلقاها إدغار فور باستغراب كبير، متهما عبد الرحيم ورفاقه بكونهم «يؤلهون الأشخاص» في سياق تعقيبه عن دفاع عبد الرحيم عن عودة محمد الخامس باعتباره المؤتمن على السيادة الوطنية، وذلك إثر تطور مفاجىء تمثل في التهامي الكلاوي الذي جدد ولاءه للملك قبل طلبه العفو في سان جيرمان أون لي، إضافة إلى فكرة المرور بمرحلة «حفظة التاج» التي دافع عنها بعض «أصدقاء» فرنسا في المغرب، وسقطت تحت مطرقة عبد الرحيم الهجومية.
بعد أسابيع قليلة، سيتم تشكيل أول حكومة وطنية بعد الاستقلال، وسيعهد وقتها إلى عبد الرحيم بوعبيد ضمن وفد رباعي بالشروع في مفاوضات مع فرنسا تتجاوز البلاغ المشترك الموقع في أواخر 55، لكن فرنسا كانت وقتها بدون مخاطب لأسباب داخلية، ولم يتم الشروع في تلك المفاوضات إلا في مطلع السنة الموالية، وذلك قبيل إجراء مفاوضات في مدريد أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع الحكومة الإسبانية تكرس بدورها الاعتراف باستقلال المغرب، واضطلع فيها عبد الرحيم بمهمة بجانب جلالة الملك محمد الخامس خلال إقامته بمدريد.
وخلال التطورات الهامة التي عرفها المغرب إلى حدود الحكومة الرابعة، أرسى عبد الرحيم عبر توظيف معرفته الاقتصادية وقدراته العقلانية الخلاقة، الملامح الكبرى للمؤسسات العمومية وهو يتحمل أكبر مهمة حساسة في المغرب المستقل وهي وزارة الاقتصاد الوطني، وفي ظل ظروف صعبة ومعقدة، ووضع حدا نهائيا للامتيازات الناشئة عن اتفاقية الجزيرة الخضراء، وفي الفترة التي شارك فيها استطاع المغرب أن يرسي دولة القانون بعد صدور ظهير الحريات العامة، وإعداد النصوص الأولى للانتخابات التشريعية.
بالطبع، حين اتخذ قرار من طرف جلالة الملك محمد الخامس بإقالة آخر حكومة حزبية ملتزمة بتنفيذ برنامج محدد في ماي 60، سيدخل عبد الرحيم مرحلة جديدة من حياته السياسية طبعت كل ما تبقى من عمره الحافل، سيصبح عبد الرحيم على رأس المعارضة التي لم تتخل أبدا عن التزامها بالوفاء للأهداف الحيوية للقوات الشعبية وللمصلحة العليا للبلاد، وعلى رأسها إنجاز الانتقال الديمقراطي والوحدة الترابية، رغم كل المحن.
ولعل جنازة عبد الرحيم في 9 يناير 1992، بكل الدلالات التي تمثلها، لا تضع رباطا بين الموت والسياسة، إذ مازال جيلنا الموتور يتعلم باستمرار من خصال هذا الرجل الكبير ومن مزاياه الإنسانية، قد يبدو أن جزءا كبيرا ممن كانوا في جنازته قد تشتتوا أو طلّقوا السياسة، كما تعلموها عن طريق «النموذج» عبد الرحيم، وقد يحن البعض منا إلى تواريخ محددة، كسنة 1962، حيث يبدو عبد الرحيم واقفا على منصة المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالدار البيضاء، أو يحنّ إلى سنة 1975 خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي وإلى ذلك الجدل الخارق للعادة الذي واكب إعداد «التقرير الإيديولوجي»، لكن الحنين ليس هو نفسه دوما، إذ ثمة ذلك الصوت الرزين الودود، وهو يتحدث بتؤدة كمن يسير فوق الغيم عن أشياء مألوفة لا يدركها ولا يستوعبها إلا المقربون، تخرج الكلمات الذكية من فمه وخلفها إيقاع الجاز العذب، المرصع بالآهات والعذاب والحشرجات، ويطرق الرجل بجفنيه ليخفي تلك النظرة اللماعة وهو ينصت وينصت وأنت تتعلم منه درس الصمت الكبير الذي يسبق أي كلام، ثم يتكلم عن الأدب في أرقى نماذجه وعن السينما والكتب التي ينبغي الاطلاع عليها، وتدرك أن من يتكلم هو أنت، لا هو، وتعلم أن سبب ذلك هو بعد المسافة، لقد صعد هو إلى السماء وازدادت في أعيننا، مرة أخرى، قامته طولا، فيما نحن هنا نحاول أن نخترق الحجب لنعيد اكتشاف ملامحه، لعلنا نستعيده، أو يعود إلينا، على الأقل، كي لا نبقى صغارا.
محمد الهرادي