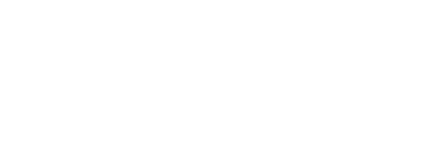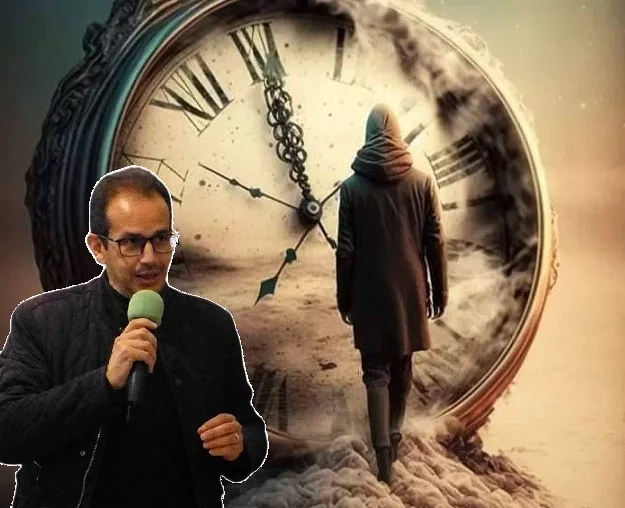
أبعاد الزمن بين السؤال العلمي والمدلول الوجودي
-
كمال الكوطي (°)
لا شيء أكثر بداهة منه، مع ذلك لا أحد يعرف ما هو. ألم يقل “القديس أوغسطينوس”: “حتماً أعرفه حين لا أُسْأَلُ عنه، لكن بمجرد ما أُسْأَلُ عنه أكتشف أني عاجز عن تحديد ما هو.”
إنه الزمن! يستهلكنا دون أن يكون بمقدورنا الخلاص منه، نشعر به دون أن نتمكن من لمسه، يلفنا من كل جانب، حاملاً إيانا في متاهاته، تارة يطول وتارة أخرى يتقلص. نعلق عليه كل آمالنا وأحلامنا وانتكاساتنا، يشدنا إليه عند الندم، يقلقنا عند الانتظار. شعورنا بالعجز أمامه دليل على أننا “كائنات لأجل الموت”، “كائنات تحيا فناءها” كما قال “سارتر”. مع ذلك نتطلع لاستكشافه، نحاول “قوله” و”الامساك به” في القصيدة كما في الرواية، في الصباغة كما في الموسيقى، في الدين كما في الفلسفة…في العلم !
فهل توفقنا في التعبير عنه؟! هذا ما حاول الفيزيائي والفيلسوف الفرنسي “اتيان كلاين” الإجابة عنه في كتابه “الزمن”، الصادر سنة 1995 عن دار النشر “فلامريون”.
إليكم مقدمة هذا الكتاب الذي أنهيت ترجمته على آمل أن يرى النور في مستقبلاً في المكتبات.
ترجمة “كمال الكوطي”، العنوان الأصلي:
Klein Étienne : Le temps, un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Éditions Flammarion, 1995
تمنحنا تجربتنا الأولية شعورا بزمن، بدونه لن تكون لكينونتنا لا نسيج ولا معاش، لدرجة يتراءى لنا أننا خاضعون له خضوعا حتميا. إنها تجربة زمن لا مرد لقدره. لهذا السبب حاول البشر دوما، دون نجاح يذكر، صياغة خطاب متماسك حوله، أي حول الزمن.
يكفي في هذا الصدد النظر إلى المكانة الكبرى، والفريدة التي يحتلها في مجالات كالآداب والفن، وفي أغاني كل العصور. كما نجد له حضورا في تعبيرات لغوية عديدة بشكل يشكل معها، حسب اعتقادنا، جزء لا يتجزأ من مفاهيمنا الاعتيادية. إننا نرى في الزمن كائنا من بين الكائنات الأليفة التي نعتقد أنه بوسعنا ترويضها.
كل منا يفهم ما نتكلم عنه عند حديثنا عن الزمن، دون أن نذهب أبعد من ذلك. من المفروض أن يكون حديثنا ذاك كافيا لمنح الحل النهائي والحاسم، وبشكل واضح ومتميز، للمشكل الذي يطرحه. لكن يجب مع ذلك الاحتياط من المفاهيم المتداولة لأنها في الغالب مفاهيم غامضة وملتبسة، وهو ما يصدق على مفهوم الزمن أيضا. الكل يشعر تماما بأن الزمن، بإيحاءاته المألوفة والبريئة، شيء متميز عن باقي الأشياء الأخرى، وبالتالي لن نتوقف قط عن مساءلته. فهل بمقدورنا تحديد الزمن دون اللجوء إلى استعاراته المعتادة؟ استعارة كتلك التي أسالت الكثير من المداد منذ الإمبراطور “مارك اوريليوس” (121-180) Marc Aurèle، والتي تشبهه “بنهر متدفق مكون من سلسلة من الحوادث؟”
نبه “بشلار” في كتابه “حدس اللحظة” ” L’intuition de l’instant، إلى أن “التفكير في الزمن هو المهمة الأولى لكل ميتافيزيقا.” إن هذا هو ما يجعل منها، أي من الميتافيزيقا، مهمة عسيرة، مهما كان المنطلق الذي نعتمده في تناولها، ذلك لأن تحليل الزمن يطرح صعوبات جمة وقاسية.
أولى تلك الصعوبات تتمثل في عدم قدرتنا على خلق مسافة مع الزمن، وذلك بخلاف ما نقوم به حين يتعلق الأمر بموضوع معتاد آخر. نستطيع بكل تأكيد قياسه، لكننا لا نستطيع ملاحظته بوضعه هناك أمامنا، لأن تأثيره فينا دائم ومستمر. نود التوقف، وتتبع مساره وهو يتدفق كنهر نشاهده على جانب الضفة دون النزول إليه. بيد أن أمرا كهذا مستحيل تماما: نحن حتما غارقون في الزمن بشكل لا يمكننا معه الخروج منه. فالزمن، بالنسبة لنا، لا خارج له.
لا يمكننا أيضا احتواءه. فحتى وإن كانت كلمة “الآن” مضارعا تاما participe présent لفعل “أبقى” (1) (بمعنى “أخذه بين اليدين”)، فإنه لا أحد بوسعه أسر الزمن ولا الإبقاء عليه، تماما كما لا يمكن ليد إيقاف تدفق نهر. فحين يتعلق الأمر بمسألة الزمن، لا وجود، كما قال “ميشال سيرس” Michel Serres، ليد قابضة main tenant. ففي الوقت الذي نفكر فيه، يحملنا معه الزمن في الآن نفسه الذي يحمل فكرنا.
ليس بمقدور الزمن التوقف عن المضي قدما، إنه لا يعرف سوى الفرار، وهذا بالضبط ما يميزه. فضلا عن ذلك لا أحد بمقدوره إيقافه أو تعليقه، لا شيء يمكنه أن يقف حاجزا أمامه، وهو ما تأسف له “ألفونس دو لمارتين” Alphonse de Lamartine كما تأسف له آخرون.
أما الصعوبة الثالثة فتتمثل في أن الزمن لا يمكن إدراكه بأي حاسة من حواسنا الخمس. أي لا يمكن إدراكه كظاهرة خام، وذلك حتى وإن كان الإنسان أكثر الكائنات “زمنية”، وأكثرها وعيا بالزمن الذي يمضي. وعليه، وحدها الكائنات التي تتوفر على الحد الأدنى من الذاكرة قادرة على الإحساس بانسيابه (فكما أنه لا فكرة للأعمى عن اللون، فإن من لا ذاكرة له لا فكرة له عن المدة durée)؛ لكن حتى وإن كانت الذاكرة قادرة على الإبقاء على جزء من الماضي في الحاضر، فإنها لا تكفي لجعل الزمن مادة قابلة للإدراك الحسي، وكذلك هو الشأن بالنسبة للحدس والخيال.
أما الصعوبة الرابعة والأخيرة، فتتمثل في كون الزمن يحضر أمامنا دوما بشكل غامض ومحير تقريبا، بل وبشكل متناقض أحيانا. إنه بديهي ومجرد في الآن نفسه، جوهري ونزقي، مألوف وغامض. وحتى وإن كان يبدو أن له وجهة، أو ما يسميه الفيزيائيون “بسهم الزمن”، فإنه يظل مع ذلك موضوعا بعيد المنال. إذا، كيف يمكن تفسيره؟ أكيد أن أي محاولة للقيام بذلك مآلها السقوط في مفارقات معقدة، وهو ما سوف نراه في الفصل الثاني من هذا الكتاب.
رغم أشكال اللبس هذه المرتبطة بالزمن لم يتوقف علماء من تخصصات مختلفة، عبر تساؤلاتهم حول الكون والإنسان، عن مواجهته الدائمة، مواجهة تقلباته، بل وحتى ظلماته. بداية سوف نخصص كلامنا لعلماء الفيزياء. قد يبدو غريبا الربط ما بين الزمن والفيزياء، مادامت هذه الأخيرة تبحث، دون أن تصرح بذلك، عن التخلص منه. ذلك لأن الزمن هو المتغير والمتحول والعابر، في حين أن الفيزياء هي بحث دؤوب عن العلاقات الثابتة والمستقرة. وحتى حين تُطبق (أي الفيزياء) على سيرورات لها تاريخ أو سيرورات تتطور، فإنها مع ذلك تحاول أن تكشف فيها إما عن جواهر أو صور، أو عن قوانين وقواعد مستقلة عن الزمن.
لهذا السبب تنزع الفيزياء إلى بلوغ ما هو ثابت وقار، أو على الأقل ما هو قابل للاعتكاس réversible (2) إن غاية الفيزياء، كما يراها ممارسوها، هي عن حق محاولة لإرجاع المتغير إلى الثابت عبر صياغة قوانين أبدية، بمعنى قوانين متحررة من الزمن، وذلك بالانطلاق من ظواهر متغيرة بطبيعتها. وعليه، أليس مطلوبا من كل من يبحث عن الحقيقة جعل اللازمني intemporel هدفا له؟
مع ذلك لا يمكن للفيزياء، في ممارستها كما في مفاهيمها، تفادي مواجهة الزمن، مواجهة تتسم بحدة أكبر بشكل يكتسب معها داخلها أوجه عديدة. لذا، تكفي العودة لاستعارة النهر المشار إليها سابقا (“الزمان نهر متدفق”) واستخراج المفاهيم الأولية التي تخفيها أو تحملها لنفهم الكيفية التي يستفز بها الزمن علماء الفيزياء. توحي هذه الصورة بمفاهيم من قبيل الانسياب، التعاقب، الديمومة، وعدم القابلية للاعتكاس (“ذلك لأننا لا نستحم مرتين في النهر نفسه”، كما قال “هرقليطس”). وبالتالي نرى كيف تحيلنا تلك الصورة إلى رموز تنتمي إلى مجال تساؤل الفيزيائيين. فهل يتعلق الأمر حقا بانسياب؟ وفي هذه الحالة يتساءل الفيزيائيون عما إذا كان انسيابا منتظما أم لا.
ثم هل الزمن صلب أم مرن؟ سوف نرى كيف أن جواب الفيزياء الكلاسيكية عن هذا السؤال مختلف عن ذاك الذي تمنحنا إياه نظرية النسبية؛ بهذا الخصوص كان “ألبرت اينشتاين” أكثر مرونة من “إسحاق نيوتن”. فهل يتعلق الأمر بالديمومة؟ في هذه الحالة يود الفيزيائيون معرفة ما إذا كان للزمن أطراف، مثل حبل، وبالتالي يتساءلون عما إذا كانت له بداية ونهاية؟ هنا بالضبط يكمن مشكل الكوسمولوجيا (3) الذي يمدد ويقلص زمنيا الكون ما بين انفجار-عظيbig-bang (4) محتمل جدا وانسحاق-عظيم big-crunch(5) أقل احتمالا (من باب الحكمة لا يتجرأ علماء الفيزياء الفلكية على تحديد تاريخ حدوثه).
ثم هل يتعلق الأمر بعدم القابلية للاعتكاس، أي باستحالة صعود مجرى نهر الزمان؟ يتساءل الفيزيائيون من جانبهم عما إذا كان انسياب الزمن قادرا أم لا على تغيير وجهته، بعبارة أخرى: هل الزمن “مُسهّم” fléché أم لا صوب المستقبل؟
يعود الفضل للفيزيائي البريطاني “ارثور ادينغتون” Arthur Eddington (1882-1944) في حمل الزمن لهذا الشعار – أي السهم flèche– الذي أبقته الميثولوجيا محصورا على “ايروس” Eros، إله الحب، الذي غالب ما يتم تمثيله بطفل مجنح يجرح القلوب بسهامه الحادة. في هذا السياق بالضبط، يرمز هذا السهم ليس للحب (مع كامل الأسف)، بل لذلك الإحساس الذي ينتاب كل إنسان، إحساس بالفرار الحتمي للزمن وعدم قابليته للاعتكاس (توحي كلمة “فرار” لوحدها بأنه حين يخص الأمر الزمان ليس من حقنا سلوك سوى مسار واحد فقط).
وعليه، سوف نفحص كيف يحصر كل مجال من مجالات الفيزياء بهذا القدر أو ذاك من الصعوبة سهمه الزمني الخاص (6)، وبالتالي سوف نرى ما إذا كان الفيزيائيون قد تمكنوا من استخلاص زمن موحد من معادلاتهم. أما في الجزء الثاني، فسوف نغادر الإطار الحصري للعلم ومن ثم استحضار سمات أخرى تهم مسألة الزمن، في كل عمقها
1- سياق الحديث هنا يخص بنية اللغة الفرنسية ومجالها التداولي (المترجم).
2- في مقال كنت قد خصصته للموسوعة العربية اقترح علي الأستاذ الفاضل الدكتور “محمد أبطوي” ترجمة اللفظ الفرنسي réversible بالقابل للاعتكاس، في مقابل غير القابل للاعتكاس irréversible (المترجم).
3- مبحث يهتم بدراسة بنية وتطور الكون، في مجمله. لا وجود لتجربة يمكنها أن تشمل الكون في شموليته، لهذا تلجأ الكوسمولوجيا إلى فرضيات وإلى استنتاجات تشكل موضوع نقاشات حادة.
4- إنه النموذج المقبول حاليا بخصوص التطوري الكوني، والذي يرى أن الكون قد عرف في البداية شروط حرارة وكثافة عالية جدا، والتي تضاءلت مع توسعه. غالبا ما يوظف هذا اللفظ بشكل لا يخلو من تعسف لوصف الخلق الانفجاري للكون.
5- إنه سيناريو متناظر لذاك الذي يخص الانفجار-العظيم، والذي قد يحدث إذا ما كان الطور الحالي لتمدد الكون مصحوبا بطور تقلص يفضي إلى شروط حرارة وكثافة عالية.
6-إنها استعارة ابتكرها الفيزيائي البريطاني “ارثور ادينغتون”، للدلالة على الفرار الحتمي للزمن، فرار من الماضي إلى المستقبل، أي صوب وجهة واحدة.
(°) باحث، أستاذ مادة الفلسفة، من أعماله ترجمة كتب “رحلة قصيرة في عالم الكوانتا” لإتيان كلاين، “الموضوع الرباعي – ميتافيزيقا الأشياء بعد هيدجر” لغرهام هرمان، و“من الكينونة إلى الصيرورة” لإليا برجوجين