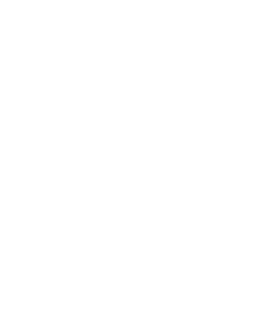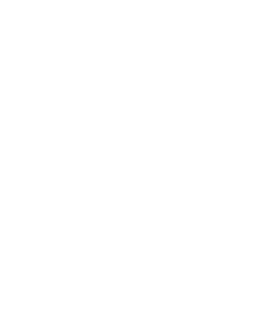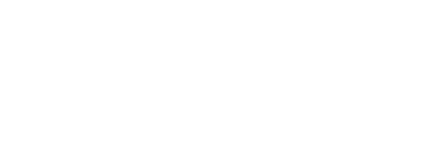أخبار عاجلة
- المعرض الدولي للكتاب والنشر: المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية
- اعتراض 133 مرشحا للهجرة غير النظامية جنوب غرب طانطان
- فيديو: الصادق الرغيوي يتحدث عن رهانات المؤتمر الوطني لقطاع التعليم الاتحادي
- بوريطة يستقبل وفدا بيروفيا من حكومة بيورا الجهوية
- ايذي: رهاننا نجاح مؤتمر قطاع التعليم الاتحادي وقضايا أساسية مطروحة للنقاش
- توقيع اتفاقية شراكة لإطلاق حزمة جديدة من مشاريع الإعمار والترميم في القدس الشريف
- المغرب يشيد باعتماد قرار يدعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة
شؤون سياسية
فيديو: الصادق الرغيوي يتحدث عن رهانات المؤتمر الوطني لقطاع التعليم الاتحادي
https://youtu.be/O77vOtUPCFc?si=yskaFppcymTnstP6
دولية
انتخاب المغرب نائبا لرئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات
تم انتخاب المغرب في شخص عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، نائبا لرئيس منتدى الأمم…
فن و ثقافة
دور مركز الدراسات الانثروبولوجية والسوسيولوجية في النهوض بالثقافة الأمازيغية محور…
خصصت مائدة مستديرة نظمت اليوم الجمعة في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، للتعريف بأدوار مركز…
صحة وأسرة
خبراء ومختصين دوليين في طنجة لمناقشة مستجدات الأمراض التعفنية
التأم أطباء ومختصون وخبراء، نهاية الأسبوع الماضي بطنجة، ضمن الدورة السابعة للقاءات الإفريقية لطب الأطفال والدورة…
المعرض الدولي للكتاب والنشر: المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية
افتتح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، امس الجمعة بالرباط، برنامج مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الـ 29، تحت شعار “إرساء المدرسة الجديدة.. مسؤولية مشتركة”، بمحاضرة حول “حكامة منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وتطرقت الجلسة الافتتاحية إلى مناقشة الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية من خلال…
الأكثر مشاهدة
استطلاع أنوار بريس